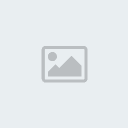فإن راحة القلب، وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه،
هو المطلب لكل أحد،
وبه تحصل الحياة الطيبة، ويتم السرور والابتهاج،
ولذلك أسباب دينية، وأسباب طبيعية، وأسباب عملية،
ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين،
وأما من سواهم،
فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه،
فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالاً ومآلاً.
ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني
من الأسباب لهذا المطلب الأعلى،فمنهم من أصاب كثيراً منها
فعاش عيشة هنيئة، وحيى حياة طيبة،
ومنهم من أخفق فيها كلها
فعاش عيشة الشقاء، وحيي حياة التعساء.
ومنهم من هو بين بين، بحسب ما وفق له.
والله الموفق المستعان به على كل خير،
وعل1- وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها
هو الإيمان والعمل الصالح،
قال تعالى:
{ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}(1).
فصـل
1- وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها
هو الإيمان والعمل الصالح،
قال تعالى:
بالحياة الطيبة في هذه الدار،
{ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}(1).
فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح،
وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار.
وسبب ذلك واضح،
فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح،
المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة،
معهم أصول وأسس يتلقون فيها
جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج،
وأسباب القلق والهم والأحزان.
- يتلقون المحاب والمسار بقبول لها،
وشكر عليها، واستعمال لها فيما ينفع،
فإذا استعملوها على هذا الوجه.
أحدث لهم من الابتهاج بها، والطمع في بقائها وبركتها،
ورجاء ثواب الشاكرين،
أموراً عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها
هذه المسرات التي هذه ثمراتها.
- ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم
بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته،
وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه،
والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد،
وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة،
والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب
أمور عظيمة تضمحل معها المكاره،
وتحل محلها المسار والآمال الطيبة،
والطمع في فضل الله وثوابه،
كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا
في الحديث الصحيح أنه قال:
"عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير،
إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له،
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن" (1).
فأخبر صلى الله عليه وسلم
أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله
في كل ما يطرقه من السرور والمكاره.
لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر
فيتفاوتان تفاوتاً عظيماً في تلقيها،
وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح.هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه
من الشكر والصبر وما يتبعهما،
فيحدث له السرور والابتهاج،
وزوال الهم والغم، والقلق، وضيق الصدر،
وشقاء الحياة
وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار.
والآخر يتلقى المحاب بأشرٍ وبطرٍ وطغيان.
فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع،
ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب،
بل مشتته من جهات عديدة،
مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته،
ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالباً،
ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد
بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى،
قد تحصل وقد لا تحصل،
وإن حصلت على الفرض والتقدير
فهو أيضاً قلق من الجهات المذكورة
ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر،
فلا تسأل عن ما يحدث له من شقاء الحياة،
ومن الأمراض الفكرية والعصبية،
ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات،لأنه لا يرجو ثواباً. ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه.
وكل هذا مشاهد بالتجربة،
ومثل واحد من هذا النوع،
إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس،
رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه،وبين من لم يكن كذلك،
وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله،
وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع.
فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر،
أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها،
فإنه - بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضى بما قسم الله له -
يكون قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمراً لم يقدر له،
ينظر إلى من هو دونه، ولا ينظر إلى من هو فوقه،
وربما زادت بهجته وسروره وراحته
على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية،
إذا لم يؤت القناعة.
كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان،
إذا ابتلي بشيء من الفقر،
أو فقد بعض المطالب الدنيوية،
تجده في غاية التعاسة والشقاء